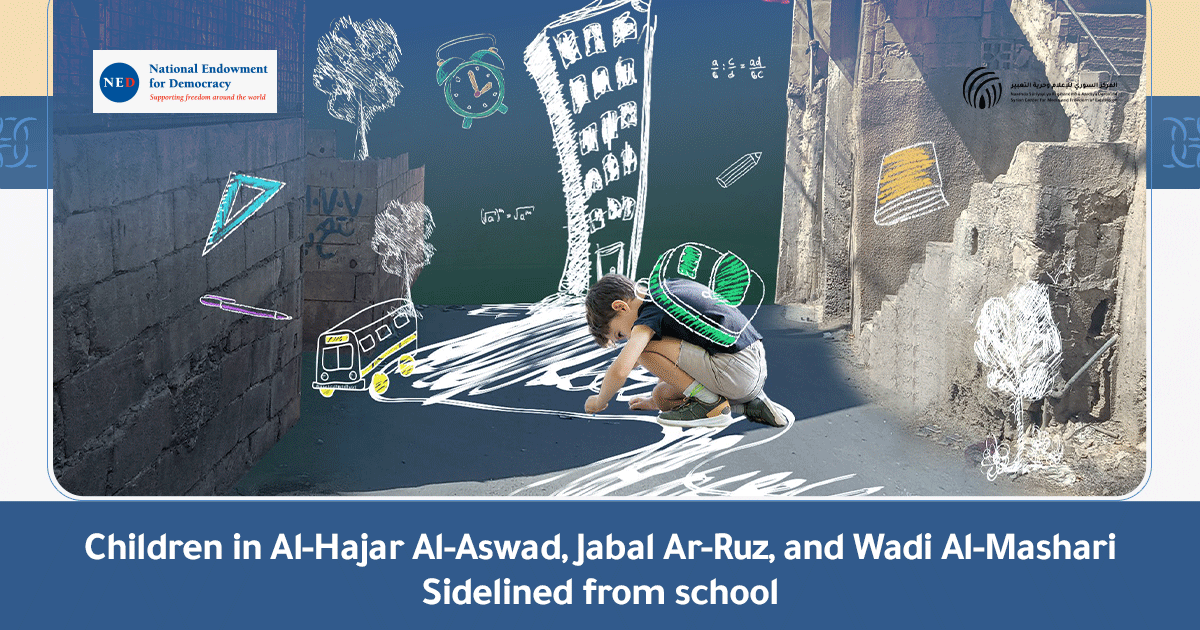إشكالية الإبداع السينمائي في تونس بين حرية الرأي والرأي الآخر
صحيفة “القدس العربي”: د.أنور المبروكي
قد تتجاوز ردات الفعل الشعبية التونسية تجاه فيلم ‘برسيبوليس’ الإيراني الذي عرض في قناة نسمة التونسية مؤخراً مجرد الاحتجاجات الشعبية المتدينة لتتعداها في حقيقة الأمر إلى ايديولوجيا خبيثة متخفية داخل منظومة سينمائية مستوردة تسعى إلى توريد عفن سينمائي مؤدلج تحت غطاء ‘الإبداع المنتهك’ وحرية التعبير المسكينة.
فنتساءل حقيقة: لماذا كان السينمائيون ‘المتفرنسون’ المصدر أو المنبع الأساسي لكل فيلم يسعى إلى المس بالعقائد الدينية على اختلافها؟ لماذا تحصل هذا الفيلم على جائزة مهرجان كان الدولي على حساب أفلام أخرى أكثر إستحقاقاً فنياً؟ لماذا تسعى هذه الفئة من اللاجئين الثقافيين إلى محاولة فرض مفهوم خاص لحرية الإبداع ولماذا هذا المفهوم اللائكي المتطرف للفن؟
ما الذي جعل فيلماً لنادية الفاني يحصل على الدعم والعرض بسرعة كبيرة 3 أشهر فقط بعد إندلاع الثورة التونسية في حين بقيت أفلام تونسية أخرى أحياناً 9 سنوات لتتحصل على دعم وإن كان خارجياً ؟ من المسؤول عن بث هذا النوع الجديد من ‘الابداعات’ السينمائية المتسيسة، ولماذا لم تعرض هذه الأفلام قبل الثورة ؟ لماذا تأتي هذه الأفلام من فرنسا بالتحديد؟اسئلة قد تتجاوز حدود الثقافة والإبداع لتتعداها إلى طرح التساؤل عن مفهوم الوصاية السينمائية. هكذا إذاً يعود بنا التأمل في المغزى من عرض هذين الفيلمين إلى إعادة نظر جادة في المعنى الحقيقي للحرية في الإبداع.تأتي الحرية في شعار الدولة الفرنسية في المرتبة الثالثة بعد العدالة والأخوة.فالعدالة شكل من أشكال الديمقراطية في توزيع الحقوق كما في تجميع الواجبات، أما الأخوة فهي قيمة إنسانية بالمنظور السوسيولوجي الديني للكلمة، بل ربما تكون ثمرة لهذه العدالة الإجتماعية. فهاتان القيمتان هما في الحقيقة مؤسستا الحرية.نسلم إذاً نظريا بهذا التحليل المنطقي أو الطرح السوسيولوجي الواضح، لكن تطبيقياً وعلى أرض الواقع نجد أن التناقض بين هذه المفاهيم الثلاثة ينقض القول بهذا الترتيب التراتبي الموهوم.
فالعدالة بهذا المنطلق اللائكي المزعوم تقوم على هواجس ايديولوجية قد تقصي كل من يخالفها الرأي دينياً فتصبح عدالة طبقة معينة أو شعب معين لا عدالة شعوب أو طبقات ويتم ذالك عبر وسائل سلطوية متخفية كما يسميها جسد الفلسفة الأركيولوجية ميشال فوكو. هذه السلطة المتخفية الموجودة بكثافة في الفن السينمائي اليوم تسعى عن طريق الاعتراف بالإقصاء أو الإقصاء بالاعتراف إلى التخفي وراء صنم الديمقراطية الموهومة فيكون أول عملها متمثلاً في الإعتراف بديمقراطية إقصاء القيم بدليل أنها عدوة للديمقراطية الأم التي تلد من رحمها الحرية فيصبح الاعتراف ديمقراطياً بهذه القيم حسب رأيهم شكلاً من أشكال التشويه بالمعنى الحقيقي للحرية.ويظل إذاً مفهوم الحرية عند هذه الفئة وليد ظروف سوسيولوجية أو بالأحرى سياسية وهي التي تتحكم غالباً في جهاز ومؤسسات الدولة التي تصنع القرار. لكن قد تخفي هذه المؤسسات حقيقةً نوعاً ما من الإستبداد في سلطة صناعة المفاهيم فيتحول مفهومها للحرية إلى نوع من أنواع السلطة على الآخرين بالمعنى البراغماتي النرجسي مما يجعلها تطلق العنان لهذا المفهوم (الحرية) لحظة كل نقد، فيتحول من الديمقراطية إلى الإستبداد بالديمقراطية دون حدود وهو ما ينتج مفهوم ‘التطرف في الرأي المستبد ديمقراطياً’ .
هكذا إذن تنقل هذه المؤسسات السمعية البصرية الحرية من نعمة إلى نقمة، من قيمة إنسانية مدافعة إلى قيمة مستبدة، فتصبح الحرية أكثر تسلطاً على الأفراد من الأفراد بما أنها صنع فئة معينة تريد نزع الاعتراف لا غير.إن مفهوم ديمقراطية الإستبداد وحرية الإستبداد بالديمقراطية أصبح اليوم من أرقى المفاهيم المعاصرة لدى تلك الشعوب التي تدعي أنها لائكية مستغلة في ذلك نظرية المبدأ الثالث المرفوع ايديولوجياً.هكذا إذن تصنع مفاهيم الحرية في كواليس مصانع الديمقراطية المزعومة فتنشأ عنها اصناف متعددة من الحريات حسب الدرجات تستهلك وفق تاريخ صلوحية معينة حسب الدول.
إن هذه الكواليس هي نفسها التي تقوم بصناعة قوالب جديدة من الديمقراطيات والحريات التي تسعى غالباً بتجسيدها في الفن السينمائي تحت غطاء حرية الإبداع، فيصبح التفنن في انتهاك الفن أرقى أنواع الفنون المعاصرة.إن من أخطر الأيديولوجيات المعاصرة اليوم هي تحالف صناع الديمقراطية المزعومة باسم الفن ضد الشعوب باسم الدين كأرقى أنواع الأحاسيس البشرية والأكثر اقتراباً من المجتمعات الفقيرة مالياً.كما إنه من أخطر أيديولوجيات الديمقراطية اليوم هو الاستغلال الخاطئ للحرية باسم الفن والفن باسم الحرية والسعي إلى الاستفزاز المقنن سياسياً ضد الدين، فلا بد من القول إذن أن سلطة السياسة كسلطة رافضة لكل الديمقراطيات التي لا تشترك في صنعها تعد من أخطر الفيروسات القامعة لحرية الأفراد اليوم وهي نفسها التي صنعت أفلاما على نحو ‘لا ربي لا سيدي ‘ لنادية الفاني أو ‘برسيبوليس’الفائز بجائزة التأدلج السينمائي، فكأن معنى الفن اليوم أصبح يستمد وجوده من معنى حرية استفزازه للدين بل تصبح الحرية في الفن مستمدة من نفس الحرية التي تهمشه، فهي قد تقصيه بفعل خدمة هذا الأخير لصنم السياسة التي هي أرقى أنواع الفكر البشري الخبيث كفكر يكشفه العقلاء ويستغله السياسيون، بالضبط مثل الثورة يخطط لهاالأذكياء ويستغلها الإنتهازيون.إن تحول الإمبريالية من مفهومها السياسي إلى مفهومها الثقافي اليوم يجعل شعوب العالم أكثر تمسكاً بالدين، لا كشكل من أشكال العناد بل كحليف أول لأولئك الفقراء الذين صودرت أحلامهم فبقي لهم الدين ملجأ.إن الفيلمين المذكورين سابقاً يكشفان حقيقةً نوع من أنواع التسلط الذي يسعى إلى صنع ردة الفعل أكثر من الفعل ذاته، فأتيا في ظروف حساسة سياسياً وإجتماعياً موجهين مباشرةً إلى شعب عاش حوالي نصف قرن من الاستبداد بكل اشكاله، فكانت الثورة بمثابة الفرصة للإنعتاق من ذالك الطغيان.
ففيلم نادية الفاني مثلاً أتى في فترة وجيزة مباشرة بعد إندلاع الثورة، قد لا تكفي أحياناً لكتابة سيناريو، فكيف إذاً يصنع فيلم بتلك السرعة، سيناريو، إخراج و توزيع؟ وهي النقطة الأكثر إثارة في الساحة السينمائية التونسية في وقت يستدعي فيه الموافقة على دعم فيلم سنوات.
إن ذلك الفيلم تسرب وبطريقة مندسة باسم الإنفلات الحر للحريات المدمقرطة في فترة حساسة جداً إجتماعياً وسياسياً وهو ما يكشف حقيقة عن تلك السلطة أو مركز البريد السريع المتعالي بديمقراطيته على ديمقراطيات الآخرين، ذلك الأب الروحي لتهميش حريات الآخرين بإسم النرجسية اللائكية المتطرفة بالإبداع.
نفس مركز البريد الباعث لفيلم نادية الفاني يعيد توظيف سيطرته ثانيةً لكن بمنظور جديد يجعل منه أكثر بعداً عن الساحة التونسية كمراقب متفرج ورقيب متسلط غير مباشر فيقوم بترجمة فيلم إيراني متطرف بالمعنى الفني للإبداع وبلهجة شعبية متملقة كما يريدها ذالك المنبت.إن دمقرطة تهميش الفن بالفن أصبحت تجارة رائدة في عصر الإنحطاط الفكري والفني اليوم وهو نفسه الذي يجعل من كل مدافع عن حقوق الشعوب في اختيار أديانها شكلاً من أشكال التخلف، بل إن الإيمان بالحق المزعوم في طرز قمصان الحريات والديمقراطية على الطريقة الفرنسية لهو أكبر أنواع التنكر لهذه الحريات والديمقراطيات نفسها، بل ان صناع الفتن باسم الفن للدين هم انفسهم المتكلمون بإسم الحرية والديمقراطية الزائفة. لقد أصبح العصر عصر ثورات يستبدل فيه الحكام بالحكماء ، فلماذا لا تستبدل فيه الديمقراطيات الزائفة بديمقراطيات حقيقية. لماذا لا نعيد النظر في هذا الثالوث المقدس فنياً (حرية – دين- فن)؟ سئلة كثيرة لا بد من إعادة النظر فيها.
اننا ندعو إلى صناعة فن سينمائي أكثر تحرراً من أيديولجيات الغربنة المتمترسة في الرقابة على الآخرين. اننا نطالب بإنتاجات سينمائية منتخبة عبر صناديق الاقتراع فنياً لا مزورة بنسبة 99 ‘، مؤمنة بالإبداع بالمعنى القيمي للجمال. اننا نريد سينما فاعلة لا رادة فعل، حاكمة لا متحكما فيها.فإذا كانت الديمقراطية حكم الفقراء بالمنظور الأرسطي فلا بد أن تكون السينما حكم العقلاء بالمنظور القيمي.
جامعة ستراسبورغ – فرنسا