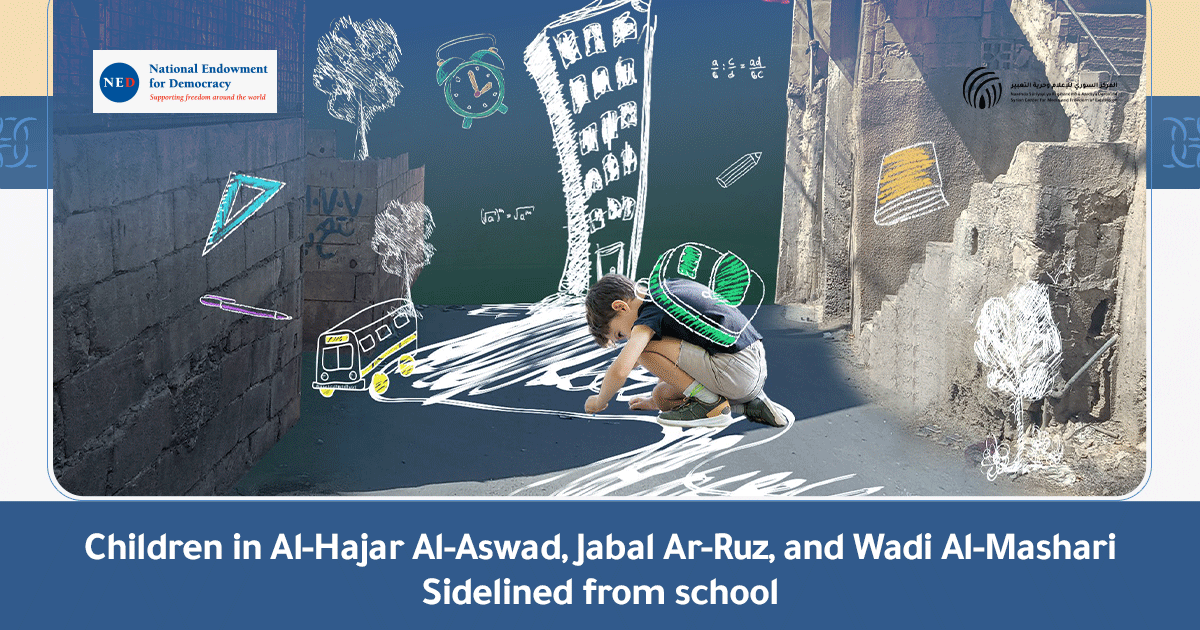د. حسان عباس
مجلة "نادي الإعلام" – العدد الثالث
أدخلت حرب الخليج الثانية تغييرا جوهريا على المفهوم السائد لوسائل الإعلام، وبخاصة على الوظيفة المعرفية، وليس التسلوية، لهذه الوسائل. لقد كان من المتعارف عليه، في هذا السياق، أن وسائل الإعلام هي مجموعة التقنيات والأدوات والخبرات التي توظفها جهة ما، عامة أو خاصة، لتتيح للجماهير المهتمة أن تتعرف إلى الحقيقة. أو، بشكل أكثر موضوعية، لتشكيل وعي بالواقع وبمجرياته يسمح بالتوصل إلى معرفة الحقيقة. لكن تلك الحرب، وما عرفته من استتباع كليّ للإعلام ووسائله إلى القيادة العسكرية المركزية نسفت ذاك المفهوم ليصبح محددا بنشر "وجهة النظر" الخاصة بالقيادة العسكرية، وترسيخها كما لو كانت هي "الحقيقة". هذا التغيير الجوهري نقل الإعلام من وسيلة لتمكين حق الإنسان في الإعلام والاستعلام، وهو من الحقوق التي تقرها شرعة حقوق الإنسان الدولية، إلى أداة هيمنة فاشية على فكر الإنسان تقطع صلته مع الحقيقة لتربطه بحقيقتها هي، وهي حقيقة مجتزأة وخادعة.
تمظهر هذا المفهوم الجديد للإعلام بتشكيل الدمجة الإعلامية- العسكرية المركّبة من شبكة الأخبار الأمريكية (سي.إن.إن) ومن القيادة العسكرية للجيوش الأمريكية المشاركة في الحرب. واعتمد تطبيقه عددا من القواعد العملية، أهمها:
1- إغلاق ميدان العمليات العسكرية أمام وسائل الإعلام غير المنضوية في الدمجة.
2- تشغيل مطرقة إعلامية تكرر دون كلل أو ملل وجهة نظر الإدارة العسكرية في الأحداث.
3- مراقبة كل ما تعدّه وسائل الإعلام وإخضاع الحق في النشر إلى موافقة "البنتاغون".
وبسبب التطبيق الحازم لهذه القواعد تفتقر محفوظات مراكز البحث والتوثيق إلى وثائق سمعية بصرية عن الحرب باستثناء الوثائق "الناعمة"، المفلترة"، الصادرة عن الدمجة، والوثائق المصورة في الفضاءات المدنية التي قصفتها الطائرات الأمريكية عن بعد، وصور "ملجأ العامرية" في بغداد أكثر هذه الوثائق شهرة.
ونظرا لتأدية هذه الدمجة للغرض الذي أنجزت من أجله، اعتمدتها الأنظمة في كل مرة تقوم فيها بأفعال لا تريد للجماهير أن تطلع عليها وتتحقق منها، لدرجة يمكن معها القول إنها أصبحت سلاحا أساسيا ملازما للممارسات العنفية التي تقودها الأنظمة ضد الشعوب، سواء أكانت شعوبها كما في إيران والصين، أو شعوبا تحتل بلدانها كحال أمريكا في العراق أو إسرائيل في فلسطين (حيث لم تكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض سوى "حالات الذعر" التي يسببها سقوط صواريخ المقاومة وتمتنع عن عرض أو حتى ذكر الجرائم التي يرتكبها جيشها ضد الفلسطينيين).
بعيد بداية الأحداث في سورية، شرع النظام السوري بتطبيق هذه الدمجة التي لم تجمع بين الإعلام والجيش هذه المرة وإنما بين الإعلام وأجهزة الأمن، مما يبرر تسميتها بالدمجة الإعلامنية. وبدأ سلسلة الإجراءات العملية اللازمة لنجاح مسعاه التسلطي. فلكي يغلق ميدان الأحداث أمام الإعلام الآخر قام بالتضييق على مراسلي الوكالات الأجنبية (طرد مراسل وكالة رويترز)، ثم أوقف منح تأشيرات الدخول للصحفيين الأجانب والعرب، ثم قام باعتقال من يدخل منهم بصفة أخرى ليمارس مهنته بعد الدخول (مثال الصحفي الجزائري خالد مهند)، وبتسفير من يحاول الدخول بطرق شرعية (مثال الصحفية البريطانية الإيرانية دورثي بارافاز)، ثم طرد الصحفيين الرسميين الذين يزلّون بالكلام أو حتى يبدون ترددا في تشرّب تقويلات السادة الأمنيين (مثال الصحفيتين سمر المسالمة وريم حداد) ناهيك عن عمليات اعتقال الصحفيين من أصحاب الأقلام الحرة (مازن درويش ولؤي حسين على سبيل المثال لا الحصر). ولكن ربما أغرب ما تم ابتكاره في هذا المجال هو أن شركتي الهاتف الخليوي المعتمدتين في سورية، وهما شركتان مرتبطتان ماليا وأمنيا بالنظام، قامتا بإلغاء اشتراك المواطنين بخدمة الأخبار المستعجلة التي تقدمها بعض المؤسسات الإعلامية الغربية كالجزيرة وغيرها، وفي هذا الأمر تَعدٍ سافر ورخيص على حق المواطنين باستقاء المعلومة من أي مصدر يريدون.
وفي ما يخص المطرقة الإعلامية، جند النظام كل وسائل إعلامه المقروء والمسموع والمرئي لبث خطاب وحيد الوجهة والسمة والموقف اتصف بدرجة أولى بالخصائص التالية:
1- اللاموضوعية في توصيف الأحداث، أي الانحياز بشكل مطلق لرؤية النظام وتحليله. حيث أصبح موقف النظام عن الأمور هو الأساس في عرض الأمور، أي وضِعت الأفكار عن الواقع قبل هذا الواقع. وفي هذا التصرف تزييف للحقيقة وتخريب للعقل.
2- عدم المصداقية التي تنبع من النقطة السابقة، لكنها تترسخ من خلال التخرّص والافتراء واختلاق التوهمات والأباطيل.
3- أدوتة (Instrumentalisation) ثقافة الخوف المعششة في حنايا السوريين، وخلق حالة من الهلع لدى المواطنين، وخاصة في بعض المكونات الثقافية التي تشكل حاضنة اجتماعية للنظام، ودفعهم إلى شحذ ميكانيزمات الدفاع الذاتي. أي إلى إيقاظ شبح الطائفية الكامن في المجتمع وهذه جريمة يحاسب عليها القانون.
4- تجييش المواطنين من خلال عمليات تلهيب المشاعر واستثمار الحمية الوطنية لغايات سلطوية محضة, وخاصة على قاعدة الدمج المطلق بين الوطن والنظام. مما ساهم بشكل خطير في استعداء مواطنين ضد مواطنين آخرين، أي في إضعاف الوحدة الوطنية وهي جريمة يحاسب عليها القانون أيضا.
5- استغباء المواطنين من خلال اختزال الوضع المركّب والمعقد إلى مزدوجة منطقية تناقضية قائمة على المقابلة بين الخير (الوطن، النظام، الإعلام الرسمي…) من جهة، والشر (المؤامرة، المعارضة، الإعلام الخارجي…) من جهة أخرى.
6- تزوير الحقائق وقلبها بحيث يصبح العنف السلطوي (بما فيه من قتل وتدمير واعتقال ومآس) سلاما اجتماعيا، وتصبح المطالبة بالإصلاح (كما مثلته المظاهرات السلمية وخاصة في بداياتها) أعمالا إجرامية.
أما عن مراقبة ما تعدّه وسائل الإعلام المباحة، فقد كان أمرا في غاية اليسر حيث أن هذه الوسائل تتحرك وتدور أصلا حسب التوجيهات الأمنية، بل إن النشر أو البث فيها لا يمكن أن يتما عادة بدون موافقة الأجهزة على المواد المنشورة.
غير أن ثمة معطيات في الواقع الكوني والمحلي لم تساعد الإعلام السوري بل أفسدت عليه سياسته ناهيك عن أنها أدت إلى نتائج عكسية في كثير من الحالات. ومن أهم هذه المعطيات التحوّل العميق في حضور وسائل الإعلام في الحياة اليومية في العالم أجمع. فالعالم اليوم، وبفضل التقنيات المتطورة لكل ما له علاقة بالميديا وبفضل الانتشار المخيف لوسائل الميديا الجديدة، يتكلم عن دمقرطة الإعلام. ويمكن أن يتضح لنا هذا الأمر من المقارنة بين سنوات الثمانينات من القرن المنصرم مثلا حيث كانت أربع وكالات أنباء كبرى فقط تحتكر نقل 95% من أخبار العالم، وأيامنا هذه حيث يأتي قسم كبير من الأخبار عبر إعلاميين غير احترافيين، أو غير ملتزمين، "يستمتعون" بنقل ما يجري حولهم، وما استجداء الفضائيات لهؤلاء لتزويدها بما يسجلونه سوى دليل إثبات على ذلك.
لقد قام الناشطون في الحراك الثوري الذي تعيشه سورية، ومواطنون عاديون، بتسجيل الوقائع اليومية للأحداث. ولم يجد الإعلام الرسمي سوى الإمعان بدمجته الإعلامنية في مجابهة تلك التسجيلات فكذبها دون أن يأتي، غالبا، بالبينة على طروحاته. بل وقع هو ذاته في ما نصبه من أحابيل، وحادثة بلدة البيضا تشهد على ذلك.
لقد أفرزت الأوضاع التي تعيشها سورية نوعا من التصادم بين نوعين من الإعلام: الإعلام الرسمي المندمج في النظام الأمني من جهة، والإعلام الحر المرتبط بالواقع من جهة أخرى. ويختصر هذا التصادم المعركة التي تخوضها القوى الوطنية الطامحة إلى المستقبل الديمقراطي ودولة القانون مع قوى التحجر والتسلط والاستنفاع، ولن تُحسم نتيجة التصادم إلا لصالح من سيخرج منتصرا من المعركة وهي، لا مجال للشك، قوى المستقبل.