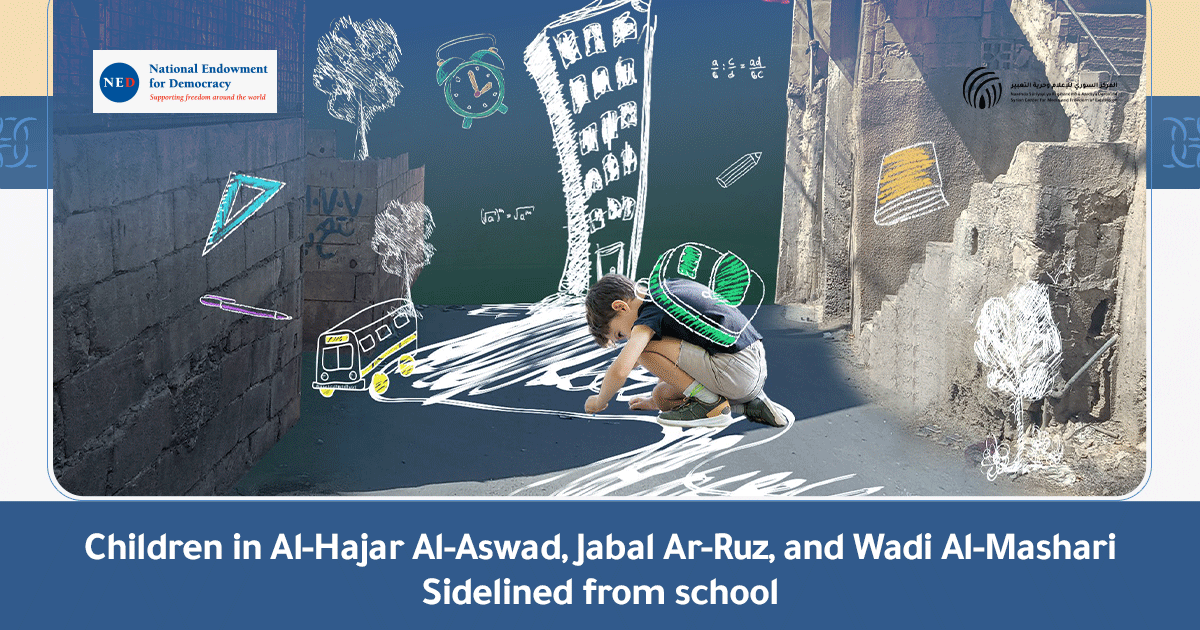دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من يارا بدر
قدّم الربيع العربي، وصيفه يقرع الأبواب، مجموعةً من التصورات الجديدة حول العديد من المفاهيم التي ترتبط بتاريخ وحاضر المنطقة العربية عموماً، مثل ‘الشباب العربي’، ‘الثورة التكنولوجية’، ‘الهوية القومية’، وسواها. رؤى أعادت إنتاج بُنى تلك المفاهيم الكلاسيكية، ممّا وضعنا اليوم في مواجهة مع مفاهيم ثورية شكلاً ومضموناً، والأهم أنّها مفاهيم اكتسبت جدّتها هذه من الممارسة التطبيقيّة لشباب الثورات العربية من تونس ومصر إلى ليبيا والبحرين، وحتى سورية واليمن.
‘الإعلام’ أحد أبرز المفاهيم التي هزّ الربيع العربي ثوابتها، كزلزالٍ ذي أثرٍ واسع الطيف، إذ أفرز الواقع العربي المُصاغ طوال عقود وفق سياسة حكومات اشتهرت بالتعتيم الإعلامي وبإحكام سيطرتها على كافة وسائل الإعلام الكلاسيكية، بهدف تغييب فاعليّة السلطة الرابعة أولاً وأخيراً، إلى جانب ضمان الالتزام الأبدي بمفردات الخطاب الإعلامي الرسمي، أفرز الحاجة إلى اختراق حواجز التعتيم الإعلامي، وإنتاج آليات إعلاميّة أخرى غير تلك الخاضعة لسيطرة مؤسسات الدول وأجهزتها الأمنية.
لم تنتج تجربة الإعلام الرسمي الذي عرفته شعوب المنطقة العربية سوى كثافة ضبابيّة في ما يتعلق بالمعلومة، حوّلت العمل الإعلامي في هذه البلاد المحكومة بأنظمةٍ شموليّة وعبر عقود طويلة إلى عملٍ إعلاني للأيديولوجيّات الرسمية، وغيّبت الفعاليّة الإعلاميّة مقابل تفشّي المد الإعلاني الذي عزل المتلقين عن حقيقة واقعهم، وأدخلهم في دائرة من الوهم حول عظمة السلطة التي يخضعون لها، حتى جاءت وسائل الاتصالات الحديثة، وخلقت شكلاً إعلامياً جديداً كسر مقولة ‘المصدر الوحيد للمعلومة’، المقولة التي عملت السلطات الشموليّة وعبر عقودٍ طويلة على تأكيدها. ومن الأمثلة التي سيذكرها تاريخ الإعلام السوري، أنّ مستشارة رئيس الجمهورية العربية السورية للشؤون الإعلامية، د. بثينة شعبان، قالت في بداية الأحداث السورية، وتحديداً في مؤتمرها الصحافي الأول انه: ‘وحيث أنّ الأحداث تجري في سورية فإنّ المصدر الوحيد الحقيقي للمعلومات هو التلفزيون السوري’.
التلفزيون السوري الرسمي، الذي أوهم شارعه أنّه ومن جديد ‘المصدر الوحيد للمعلومة’، وكل ما تنشره وسائل الاتصالات الحديثة من ‘فيديوهات’ على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ‘يوتيوب’، ‘فيسبوك’ و’تويتر’ ليس سوى ‘زيف’ و’تلفيق’. أمّا الفضائيات الإخبارية التي تنقل الخبر من زاويتها، فهي وحسب الإعلام الرسمي أيضا، ‘مُغرضة’ و’معادية’، وكل من يتعاون مع هذه الفضائيات أو يُشاهدها ‘مدسوس’ و’خائن’ لأمن الوطن.
من هنا، شكّلت وسائل الاتصال الحديثة التي لجأ إليها شباب التغيير في العالم العربي المنفذ الوحيد لتقديم صورة أخرى، وخطاب مُغاير، لما يقدّمه الإعلام الرسمي بخصوص وقائع ما يجري في الشارع إلى العالم أجمع، خاصّة في سورية التي منعت وبشكلٍ كامل الإعلاميين من دخول أراضيها، وتعددّت الانتهاكات التي مارستها الحكومة وأجهزتها الأمنيّة بحق الإعلاميين الذين كانوا على أرضها خلال الأحداث، أو حاولوا الدخول إليها. فكانت مواقع التواصل الاجتماعي أدواتٍ هشّمت جدار الإعلام الرسمي الفولاذي ومقولته الواحدة، مساحات نجح الشارع السوري ومن خلالها في أن يقول: أنا هنا، أنا موجود، أنا خائف، وربما لم أعدّ خائفاً.
إنّ الفاعلية الكبيرة التي حققتها وسائل الاتصال الحديثة في معادلة التغيير السياسي التي قادها الشارع العربي، فتحت باب النقاش واسعا على قوّة الشكل الإعلامي الجديد الذي وإن قارب ذاك الإعلام الكلاسيكي من حيث ركائز العمل الإعلامي ‘المُرسِل والوسيلة والمتلقي’ فإنه لم يُطابقه ‘من حيث الآليّات والفاعليّة’، وما بين الاثنين نهض السؤال حول مفهوم ‘الإعلام’ بحد ذاته، ومختلف المفاهيم المرتبطة به.
بدأ تخلخل التعتيم الإعلامي من انتشار القنوات الفضائية الإخبارية الخاصة أولا، التي تتحرّر – وإن شكلياً- من الترابط المباشر مع المؤسسات الحكومية والخطاب الإعلامي الرسمي، وهذا أمر لم يغب عن سياسة حكومات البلدان العربية وإنّ بعضها كسورية وليبيا حاربت إمكانية الحصول على تراخيص لإنشاء قنوات فضائية إخبارية خاصّة، وحصرت الأمر بقنوات الثقافة والمنوعات والترفيه. من هنا كان انتشار قنوات الاخبار الخاصة مساحةً جديدةً لإذاعة الخبر، وذهب الإعلام في المنطقة العربية باتجاه ‘الخبر’ وأهميته، لنشهد مرحلةً قصيرة الأمد- نسبةً إلى عمر الصحافة العربية – من الصراع على المعلومة، والتنافس على السبق الإعلامي، والطموح تصبو بالعاملين في الحقل الإعلامي لتحقيق فاعليّة السلطة الرابعة من حيث صناعة الرأي العام، وهو الأمر المستحيل التحقق في ظل حكومات شموليّة تلغي الآخر من أي خطاب، وتتمسّك برؤيتها الواحدة وتسويق خطاباتها الأيديولوجية.
لم يستمر الصراع على المعلومة طويلاً في البلدان العربية نظراً لما أفرزه الربيع العربي من واقع جديد، فككّ آليات المنظومة الإعلامية الكلاسيكيّة، عبر مجموعة أدوات جديدة صاغت شكلاً إعلامياً مُغايراً للشكل التقليدي، إن صحّ القول. ففي زمن الثورات العربية لم يَعد ممكناً حصر الخبر بوسائل الإعلام الرسمية، إذ تفتح الفضائيات الإخبارية مساحاتها لعرض مختلف الأخبار، من جهة. ومن جهة ثانية أعاد شباب التغييّر إنتاج فاعليّة مواقع التواصل الاجتماعي، محوّلين إياها إلى وسائل إعلامية عبر عرض مقاطع الفيديو التي صورها من كان حاضراً في ‘ساحات الحدث’ بكاميرات أجهزة الموبايل. ليكون مقطع الفيديو هذا هو الخبر الجديد المنشور أمام جميع متصفحي مواقع التواصل في مختلف أنحاء العام، وليكن الخبر الذي تتناقله وسائل الإعلام في ظل غياب مراسليها الخاصين.
وعليه ظهر ما يُعرف اليوم بالإعلام البديل، بمفرداته الجديدة، حيث شكّلت كاميرا الموبايل أو الفيديو بديلاً لكاميرا القناة الإخبارية، وغدت مواقع التواصل الاجتماعي والمدوّنات مجالاً للعرض الإخباري، ولإعلام تفاعلي شديد الحيويّة، أمّا من صوّر ونقل الخبر، وأطلق عليه بعض المراقبون صفة ‘المواطن الصحافي’ فغدا القائم مقام الصحافي. أخيراً وليس آخراً، تراجع أداء الإعلام الورقي، كما يمكن الملاحظة بالنظر لتجربة الثورات العربية، أمام أداء الفضائيات المفتوحة البث على مدار الساعة لملايين المشاهدين، إذ هل يمكن للمطبوعة الورقية أن تواكب سرعة كلمة ‘عاجل’، أو أن تغطي المساحة الإخبارية الواسعة التي للفضائيات الإخبارية أو لمواقع عرض مقاطع الفيديو تغطيتها؟! وهل يمكن للكلمة أن تكون أشدّ أثراً من الصورة؟
من هذه التباينات ما بين الإعلام الكلاسيكي والإعلام البديل ظهر السؤال الأساسي عن ‘الإعلام اليوم’، ما هو دوره؟ ومن هو ‘الإعلامي’ اليوم، وهل لازال الإعلاميون أسرى الصراع على ‘الخبر’؟
ألغت تقنيّات الإعلام البديل الصراع على احتكار المعلومة، ووّسعت مجال انتشار الخبر أمام مختلف الشرائح من المتابعين، بما يكسر احتكار الخبر وقمقم التعتيم الإعلامي الذي تفرضه بعض السياسيات، الحكومية أو حتى الإعلامية لمصالحها المالية. لكن هل يصنع انتشار الخبر الرأي العام؟ إنّ عرض الخبر وحده يُبقي المجال واسعاً أمام تعددّ القراءات، خاصّة في ظل إمكانيّة انتزاع الخبر من سياقه وموضعته في سياقٍ آخر، ربما يكون مغايراً بشكل كامل للسياق الأساسي.
أعود هنا إلى تجربة الإعلامي الخاص جداً إدوارد. آر. مورو في محاربته لحملة السيناتور الأمريكي جون مكارثي، المعروفة بالحملة ‘المكارثية ضدّ الشيوعيّة’ في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في أمريكا، التي انطلقت من خبر نشرته إحدى الصحف وتحوّلت بجهد مورو إلى سجال إعلامي عبر برنامجه التلفزيوني، سجال انتهى إلى وقف هذه الحملة لصالح التأكيد على مبادئ الدستور التي تضمن حريّة الرأي والاعتقاد والانتماء، إذ إنّ الصحافة ليست الخبر وحده، إنّ الصحافة من حيث هي سلطة رابعة تتضمّن بالضرورة السجال الإعلامي الذي يعرض لمختلف وجهات النظر، كما تقدّمها الأخبار، ويفتح المجال لمعرفة أكبر من حيث القيمة ومن حيث عدد الممتلكين لهذه المعرفة. وفي سيرورة صناعة الرأي العام يتسلّح الإعلامي بما يحتاجه من إحصاءات أو أبحاث أو دراسات أو صور وشواهد، وسواها.
إنّ صناعة الرأي العام التي يُنتجها السجال الإعلامي هي النقطة الرئيسيّة التي تستمد الصحافة منها قوتها، وعليه جهدت الحكومات الشموليّة على منع أي خطاب إعلامي مُغاير لخطابها الأيديولوجي من الوجود في شوارعها، ولهذه الغاية سنّت بعض الدول – مثل سورية – قوانين وتشريعات تنتهك مجال العمل الإعلامي في صيغ مطاطيّة فضفاضة، حيث يُحاكم بالسجن والغرامات الماليّة من يُتهم بـ (نشر معلومات كاذبة من شأنها وهن نفسيّة الأمة وإضعاف الشعور القومي). وفي الوقت الذي لم يمتلك فيه ممارسو الإعلام البديل حرفيّة مهنيّة عالية تسعفهم في إنتاج سجالهم الإعلامي الخاص، على الرغم من خاصيّة التفاعل الحيوية التي تتضمنها مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تكامل عملهم مع عمل الفضائيات الإخبارية الخاصة لإنتاج خطاب إعلامي مؤثر في صناعة الرأي العام العربي، إذ حقق هذا التكامل سرعة الخبر ومختلف شروط صناعة السجال الإعلامي الأخرى، الأمر الذي نجح في صياغة مفردات جديدة لواقع عربي جديد، وأطلق الأسئلة حول مصير الإعلام الورقي، الذي عانى من ضعف إمكانية مواكبة سرعة ومدى انتشار ‘الخبر’، إضافة إلى ارتباط أغلب مطبوعاته بأحاديّة وجهة النظر من دون أي قيمة تفاعلية، ليبقى أفضل ما قدّمه في ظل الواقع الجديد هو المقالات التحليليّة والأبحاث النظرية حول هذا الواقع، إرهاصاته وأفقه، وكأننا نرى في مصير الإعلام الورقي شبيهاً بدور الفن المسرحي اليوم بعد أن سحبت منه فنون السينما والدراما التلفزيونية فاعليّة العرض المباشر للقضايا المعاشة، فكرياً أو اجتماعياً أو سياسياً، دور المُحاكِم الأكثر شموليّةً لكل ما جرى، وما يجري.